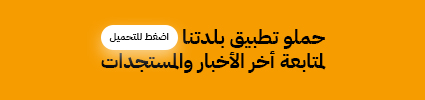الشيخ رائد صلاح
لستُ طبيبًا نفسيًا، ولكن وفق ثقافتي العامة أعلم أن من أخطر الأمراض النفسية هو (فصام الشخصية)، ولستُ خبيرًا بكل أسباب هذا المرض وأعراضه ونتائجه، ولكن ما أعلمه أن الإنسان المُصاب (بفصام الشخصية) يعيش في داخله شخصيتان، ويكون له التقلب الدائم بين هاتين الشخصيتين، وقد تظهره شخصيته الأولى للناس بمظهر الإنسان الرزين والحليم والأديب، ولكن إلى جانب هذه الشخصية الأولى هناك شخصيته الثانية التي قد تكون قائمة على سوء الظن بالآخرين والشك بأقرب المُقربين ونزع الثقة منهم وتأويل أقوالهم وأعمالهم تأويلًا ظالمًا يضعهم طوال الوقت في قفص الاتهام وينزع عنهم أية خصلة خير ثم إذا ما استفحلت هذه الظنون القبيحة والتأويلات الظالمة في داخل هذا المُصاب بفُصام الشخصية فقد تدفعه إلى إلحاق الأذى بأقرب المقربين إليه سواء كان هذا القريب زوجة أو ابنا أو بنتًا أو أبًا أو أمًا، وكم هي نكدة حياة هذا المُصاب بفصام الشخصية، إلا أن تتداركه رحمة الله تعالى، وكم هي نكدة حياة أي مجتمع حتى لو كان غارقًا في الرفاه الدنيوي إذا أصيب بفُصام الشخصية وأصبح من الجائز تسميته بمجتمع فصام الشخصية!!
والمثال الصارخ على ذلك هو مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، فهو مجتمع غارق في حب الدنيا التي فتحت له أبوابها، ولكن تراكمت فيه الأعراض بلا توقف منذ نكبة فلسطين حتى عام 2024 مما جعل الكثير منه اليوم في مرض فُصام الشخصية، وها هي أعراض هذا الكثير من مجتمعنا المؤسفة والتي لا تُعد ولا تُحصى تشير إلى أنه دخل في مرحلة الإصابة بفصام الشخصية، فما هو في قلب هذا المجتمع المُطارد -في الغالب- مختلف عما هو على لسانه، وما تحمله مشاعره لا ينعكس على سلوكه، وما يفتخر به من ثوابت باتت محنطة ولا دور لها في حياته، وها هي هويته في واد وولاؤه في واد آخر، وها هي جذوره باتت مفصولة عن حاضره ومستقبله، ولو قيل له: من أنت؟! لتلعثم ولضرب أخماسًا بأسداس، ولألجمته الحيرة وعقدت لسانه البلبلة، ولوجد نفسه في معاناة بعد كل جواب يقول فيه من هو، فلو قال: أنا أقلية، لقيل له: هذا الجواب غير كاف وعليك أن تُحدد أية أقلية أنت، ولو قال: أنا أقلية فلسطينية، لقيل له: إذًا أنت طابور خامس، تعيش على أرض أقرّت هيئة الأمم المتحدة أنها أرض إسرائيلية، ولذلك فأنت غريب عن هذه الأرض، والأولى لك أن تنتقل إلى أرض غير هذه الأرض، فلك أن تنتقل إلى السلطة الفلسطينية، أو أن تنتقل إلى مواقع الجاليات الفلسطينية في شتى الدول العربية، وإلا أن تنتقل إلى أية دولة في سائر قارات الدنيا!!
وإن ماحك هذا المجتمع المسكين وأصر على جوابه وقال: أنا أقلية فلسطينية، وأعيش في أرضي وبيتي ومقدساتي التي ورثتها عن أجدادي وآبائي، فقد يجد نفسه معتقلًا خلف القضبان، بتهمة أنه يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ما قبل نكبة فلسطين، وما قبل عام 1948، وما قبل قيام دولة إسرائيل، وما قبل قرار هيئة الأمم المتحدة الذي اعترف بقيام دولة إسرائيل، وقد يجد نفسه يُحاكم وتمطره النيابة الإسرائيلية بوابل من الأسئلة وتقول له: أنت لا زلت تزور القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا يجعلك مُتهمًا أنك لا تعتقد أنها مُهجرة، ولا تعتقد أنها أصبحت في حيازة دائرة أراضي إسرائيل، مما يعني أنك تدعو إلى التحريض ضد دولة إسرائيل في زمن الحرب، وتدعو إلى بث الكراهية ضد المجتمع الإسرائيلي في زمن الحرب، ثم إن زيارتك لهذه القرى الفلسطينية المُهجرة يجعلك متماهيًا مع حق العودة، وهذا يعني أنك لا زلت تدعو إلى حق العودة، وهذا يعني أنك تدعو إلى إزالة دولة إسرائيل، وهي تهمة خطيرة وفق قانون القومية تجعلك متماهيًا مع العدو في زمن الحرب، ووفق لائحة عقوبات هذه التهمة قد يُحكم عليك بالسجن لسنوات، وقد يُحكم عليك بالطرد إلى الضفة الغربية أو إلى غزة أو إلى دولة أخرى!!
ثم قد يُقال لهذا المتجمع لو ماحك أكثر: أنت مُتهم بالتعبير عن حُبِك للقدس، وقد قلت: القدس في القلوب، وأنت مُتهم بإعلان حُبك للمسجد الأقصى، وقد قلت: المسجد الأقصى في العيون، وهذه أقوال في غاية الخطورة لأنه وفق الخبراء الباحثين الإسرائيليين فإن هذه الأقوال تحمل إنكار حق اليهود في (أورشليم) وفي (جبل الهيكل) وفي (حائط المبكى)!!، وهذا يعني أنك تدعو إلى الكراهية الدينية وإلى اللاسامية خبيبي، وهذا يجعلك عرضة لمُصادرة بطاقة شخصيتك، وشطب مواطنتك وترحيلك في كل لحظة خبيبي!!، ولو شطح البعض من هذا المجتمع وقال تَقِيَّة: أنا أقلية غير مُعَرّفة رُبِطَ مصيرها بالمجتمع الإسرائيلي لقيل له: لا يمكن لك أن تحظى بهذا الشرف، وها هو قانون القومية يحظر عليك أن يُربط مصيرك بالمجتمع الإسرائيلي!!، وإلزم حدك ولا تتجاوز قدرك، فما أنت إلا تبع لا وزن له ولا ثقل ولا تقدير، ولك أن تأكل وتشرب وتنام وتلبس، ولك أن تبني بيتًا وتقتني سيارة، ولك أن تتعلم وأن تتقدم حتى تحصل على مرتبة الدكتوراة وما بعدها، ولك أن تُشرف على أقسام علاجية في المستشفيات، ولك أن تخوض لعبة الكنيست وأن تكون عضوًا فيها، وأن تنخرط في ائتلاف حكومي، ولكن بشرط ألا تتجاوز قدرك، وألا تخرج عن إطار الدائرة التي تشكل مساحة حياتك وإمكانيتك فما أنت إلا طاقات استهلاكية ومهن وتخصصات استهلاكية، وإلا إن خرجت عن هذا النص فالويل لك، فما أسهل أن تُحاك ضدك تهمة وأن تُلقى في السجن بضع سنين على لا شيء، وما أسهل أن تُشاع عليك الإشاعات وأن تُرجم بالظنون وأن يُشيطنك الإعلام!!
وهكذا وجد الكثير من هذا المجتمع نفسه في حيص بيص، ولا يستطيع أن يُعرّف نفسه حقيقة إلا من باب الضريبة الكلامية كأن يقول أنا أقلية فلسطينية، ولا يستطيع أن يعيش الحياة الفلسطينية، وهو لا ينتمي إليها حقيقة، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يُربط مصيره -ولو من باب المناكفة- بالمجتمع الإسرائيلي.
وهكذا باتت غالبية هذا المجتمع في منزلة بين منزلتين، فلا هو ينتمي إلى المجتمع الفلسطيني، ولا هو مسموح له أن يُربط مصيره بالمجتمع الإسرائيلي!!، وهكذا يشعر هذا المجتمع اليوم باللا إنتماء، وكأنه مجتمع في مهب الريح، لا انتماء له لأي مجتمع في الأرض، ويوم أن يفقد هذا الشعور بالانتماء إلى مجتمعه الأوسع الذي وُلد فيه ونما فيه حتى بلغ سن الرشد، فإن هذا المجتمع يتحول تلقائيًا إلى مجتمع أجوف، ومقطوع عن ثوابته وقيمه وأخلاقه، وميت الشعور بالانتماء إلى شعب يحتضنه، وإلى أمة تواكب مسيرته وتأخذ بيده إذا ما تعثر، وهكذا انتهى المطاف بالكثير من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، فما عاد يشعر حقيقة بالانتماء للشعب الفلسطيني، إلا من باب التصريحات التي تخرج من فمه ميتة، وما عادت الكثير من الأجيال الشابة في هذا المجتمع تلتزم بثوابت ترسم لها مسار حياتها، ولا قيم تهذب سلوكها، ولا أواصر تشدها إلى أبعادها الإسلامية العروبية الفلسطينية، كأنها شيء آخر، وكأن لها حاضرًا ومستقبلًا آخر، وكأن لها مصيرًا آخر، ويا له من تيه أقسى من تيه بني إسرائيل في سيناء، وهكذا أصبحت في داخل الكثير من هذه الأجيال الشابة في هذا المجتمع القابلية للانفلات، وهو العامل الأساس الذي دفع هذه الأجيال الشابة في هذا المجتمع لاستباحة العنف كمنهج حياة لها، ولاستباحة قتل بعضها بعضا بلا أدنى تأنيب من ضمير، وكيف يؤنبها ضميرها وقد مات أو أصبح مُغيبًا في أحسن الأحوال!!
وكم أصبح سهلًا على البعض من أبناء هذا المجتمع المُصاب بفصام الشخصية أن يتنازلوا عن لغتهم العربية تدريجيًا، حيث باتت لغة خطابهم ولغة كتابتهم في مواقع التواصل لغة بين منزلتين، فلا هي لغة عربية، ولا هي لغة عبرية، بل هي لغة المجتمع المُصاب بفصام الشخصية في لغته كما هو مُصاب بفصام الشخصية في هويته وانتمائه وثوابته وقيمه، وهي مأساة كبرى أشد من مأساة الهنود الحمر الذين داست عليهم مدنية الرجل الأبيض وأقامت على حساب وجودهم وكينونتهم ناطحات السحاب في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وسائر التوابع، ولأن الكثير من هذا المجتمع يكاد أن يصل إلى الحضيض في فصام شخصيته إلا من رحم الله من أبنائه، فما عاد يتوارى من الخجل إذا أقام أعراس الغناء والرقص وأعراس الولائم الفاخرة في القاعات الفاخرة في الوقت الذي لا تزال تستفحل فيه المأساة الإنسانية بغزة، وكأنه حتى الخيط الرفيع الذي اسمه الإنسانية ما عاد يربطه التعاطف مع ضحايا غزة من الأطفال والرضّع والخدّج والنساء والمُسنين والمُسنات، وما عادت طائفة من هذا المجتمع الموبوء بفصام الشخصية تتوارى من الخجل إذا أكثرت من لغة التملق والتزلف والانبطاح للسيد الإسرائيلي بادّعاء أن هذه اللغة هي قمة البراعة السياسية، وقمة الواقعية وبعد النظر والذكاء الدبلوماسي وقمة إتقان لغة المناورة والسير بين النقاط!!
ولقد انعكس هذا التخبط في وحل فصام الشخصية الذي يُعاني منه هذا المجتمع على بعض ما نبت فيه من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومشاهدة إلا ما رحم الله تعالى، ومن يتدبر خطاب هذه الوسائل الإعلامية يجد صدق ما أقول إلا ما رحم الله تعالى!!، فيا لها من فاجعة تكاد أن تودي بهذا المجتمع، ويا لها من جائحة أخطر من السرطان والكورونا والزلازل والبلابل ألمت بهذا المجتمع!!، وكم هو بأمس الحاجة كيما يُحجر على طائفة منه في غرفة الإنعاش!! لعل!! ثم وفق دراستي لتاريخنا الإسلامي العربي الفلسطيني وما شهده من حالات عثرات ثم نهضة أقول بيقين لن يصلح هذا المجتمع المُصاب طائفة منه بفصام الشخصية والذي هو مجتمعنا إلا تجديد دورة الإصلاح والتغيير القائمة على تزكية الأنفس!!، وحول ذلك يطول الحديث.